على خلاف ما أبدأُ به جميع مقالاتي، سأطلب منك عزيزي القارئ أن تشعر بقدميكَ اللتين تلامسان الأرض، و أن تتعرفَ مُجددا على المساحة التي أنت فيها الآن: لون الجُدران، الأريكة، الورود، الأوراق و الأقلام المُبعثرة. صوتُ الهواء، والسيارات و الحافلات في الطرقات.
أستشعرُ محيطي معك وأنا أكتب - و بما أن مُحيطي و مُحيطك يختلفان - اسمح لي أن أصف لك الغُرفة التي أكتبُ منها.
أمامي شاشة الحاسوب، الضوء ينعكس على وجهي. أصابعي تُلامس لوحة المفاتيح
و الصوتُ يتناغم كُلما ضغطتُ على حرف: تِك تِك تِك. أوراقي مُبعثرة على الطاولة، دفترٌ أزرق مُمزق، و دفترٌ أحمر فوقه أرسمُ فيه أجسادًا و وجوهًا و عيونًا.
والآن لا يسعني إلا أن أعترف بإنني لا أصفُ واقعي، بل هَلوساتي أم كما نقول في علم الأعصاب، بالإدراك.
فحتى أصف ”الواقع“ كما هو، يجب علي أن أتجرد من الصفات التي لا تتواجد في الواقع الفيزيائي.. و يصعبُ علي وصفه، كما سيصعب علي تخيله دون أن أُعيد بناء فكرة الطاولة من جديد.
أتخيل طاولة خَشبية بلونها البُني، مُربعة الشكل، فإنْ ضربتُها شعرتُ بمقاومةٍ فورية، قد يدفعني الخشب للخلف، و سأسمع صوت مُجوف، مكتوم نتيجة لضربي. و حتى أستشعر بالطاولة بكامل أبعادها الحِسية، أتخيل رائحتها: بقايا شجر، الألياف، الساق، و الطين الذي كان حول الخشب. و حتى طعمُ الخشب: باهت، رمادي، مرير، جاف. و الواقع أن كُل ما أتخيله، لا يتواجد كما قد أتصوره. أعجز عن وصف ما هي”الطاولة“ بلا أن أصف لونها، شكلها، خشونتها، رائحتها. و هكذا يبدأ التناقض بين الواقع المادي الموضوعي و الواقع الحِسي المُدرك.
”واقع“ الطاولة سيكون بلا لون، بلا صوت، بلا طعم، بلا ملمس و لا حدود.
لنتصور الان الطاولة كما هي في الواقع المطلق - لا تمتلك لونًا بل موجات كهرومغناطيسية بطول موجي معين تنعكس عن سطح الطاولة. أما اللون فليس سوى ترجمة عصبية لتلك الموجات. إذا وطُرِقتْ لا تُصدر صوتًا، فالصوتُ ليس سوى ذبذبات ضغط هواء - و لا تمتلك الطاولة ملمسًا أيضًا بل فقط قوى تنافر ذرية تمنع اليدين من اختراقها. لا تمتلك حتى شكلًا بالمعنى الذي نراه، بل تتكون من كثافة مادية في موضع معين من الفضاء، يُفسرها الدماغ كهيئة ثُلاثية الأبعاد.
أنا لا أنكر وجود الطاولة و الحائط و الورود و الأوراق المُبعثرة - فكُل من تلك لها واقعها الخاص خارج إدراكنا، بلا أي منطق حِسي. رُغم عُمق إدراكنا بألوانها و أصواتها و ملمسها، لكنّها لا تتعدّى كونها هلوسات عصبية.
بهذا نتفق بأن للواقع وجهينِ : وجهٌ حقيقي موضوعي فيزيائي بحت لا يحتاج لإدراكنا حتى يتواجد. و وجه مرن مُهلوِس ذاتي غير فيزيائي.
يقول عالم الأعصاب أنيل سيث، إنه إذا أردنا تعريف الوجه الأخر للواقع قد نقول أنه الهلوسة المُتفق عليها عند ”أغلب“ أدمغة البشر. و برأيي كَونه متَّفقًا عليه لا يعني أنه أكثر حقيقة من دماغ يُناقضه بالترجمة، فلا يُوجد للحقيقة شكلًا ثابتًا واحدًا.
الواقع يتم بناؤه، خلقه، تَكوينه و لا توجد له صورة ثابتة. نحن لا نرى ما نسميه واقعًا من الخارج بل نراه من خلال رؤوسنا، بين جُدران الجُمجمة
و كما تقول أنايس نين ”نحن لا نرى الأشياء كما هي، بل نراها كما نحن عليه“
و ينطبق هذا على مُختلف الحقائق - تبدأ بالأختلافات البصرية و الخدع النظرية و تمتد إلى المُعتقدات و النظرة الذاتية الأيديلوجية للمجتمع و الأرض و الانسان.
و سأتطرق لاحقًا، بتقدم المقال، إلى دور البيولوجيا العصبية في الانحيازات الحِسية و الفِكرية
المشهد البصري هو أول و أهم أبعاد واقعنا.. نرى من خلاله العالم، و يرانا باقي العالم من خلاله. و لكن عملية ”الرؤية“ هذه رُغم سُرعتها إلا إنها أعقد مما قد نتصور و حتى أتجنب طمس مقالي و حروفي بطابع علمي بحت، سأشرح آلية الرؤية بأسطرٍ قليلة، فعلمية الرؤية بحد ذاتها تستحقُ مقالًا.
الرؤية تبدأ عندما يتركّز الضوء على الشبكية، حيث تقوم الخلايا المستقبلة للضوء بتحويله إلى إشارات كهربائية، تنتقل هذه الإشارات عبر محاور خلايا العقد الشبكية. تعبر نصف الألياف البصرية إلى الجهة المقابلة في التصالب البصري، مما يتيح لكل نصف دماغ معالجة النصف المعاكس من المجال البصري. تنتقل الإشارات إلى النواة الركبية الوحشية في المهاد، ثم إلى القشرة البصرية الأولية في الفص القفوي. في القشرة، يُعاد بناء الصورة وتحليل مكوناتها كالشكل واللون والحركة، وتتكامل لاحقًا لتكوين المشهد البصري الكامل: مرحلة الإدراك البصري.
إذن الرؤية بناء مُستمر يصنعه الدماغ - و لكن الرؤية بحد ذاتها لا تتواجد بلا الإدراك (perception) يبدأ التناقض هذا في مَرضى سليمَيِ النظر، حِسيًا يستطيعون رؤية الألوان و الأشكال و الحركة و الوجوه، و لكنهم يعجزون عن التعرف و تفسير تلك المعلومات البصرية، أي لا يتحد البصر مع المعنى.
في مقالة أوليفر ساكس « أن ترى و لا ترى» التي نُشرت أولًا في مجلة (The New Yorker)، و أُدرجت لاحقًا كفصل في كتابه "أنثروبولوجي على كوكب المريخ“
نتعرف على رجل يُدعى فيرجيل، في الخامسة و الخمسين، يَستعيد حاسة البصر، بعد أربعة و خمسين سنة من إصابته بالعَمى (إعتام عدسة شديد كتاراكت) و لحسن لحظهِ، قام الدكتور سكوت هاملين، بإجراء جراحي بسيط تحت التخدير الموضعي و أزال الكتاراكت (إعتام العدسة) من عين فيرجيل.
ولكن... هل كان فعلًا الأمر لحُسنِ حظِّه؟ فلم يستطيع فيرجيل أن يرى رغم إستعادة بصره الحِسي بشكل كامل.
في أيلول، بعد الإجراء الذي أقامه د. هاملين، حين تم نزع الضماد عن فيرجيل.. لم يسمعوا صراخًا و لا أحتفالًا ”أنا أرى!!“.. حين قابل العالم للمرة الأولى، وقف صامتًا، ضائعًا. وصف لاحِقٍا انه لم يفهم ما الذي يراه: أضواء، الوان، حركة جميع تلك الأبعاد مُشوشة بلا مَعنى واضح.
يشرح لنا ساكس في مقاله: ” لكن هل يمكن أن يكون الأمر بهذه البساطة؟ أليست الخبرة ضرورية للرؤية؟ أليس على الإنسان أن يتعلّم كيف يرى ؟ عندما نفتح أعيننا كل صباح، فإننا نطلّ على عالمٍ قضينا عمرًا نتعلّم كيف نراه. العالم لا يُمنح لنا جاهزًا؛ بل نصنعه نحن من خلال التجربة المتواصلة، والتصنيف، والذاكرة، وإعادة الربط. لكن عندما فتح فيرجيل عينه، بعد أن كان أعمى لمدة خمسةٍ وأربعين عامًا وقد كانت تجربته البصرية لا تتجاوز ما يملكه الرضيع، ثم نُسيت مع الزمن لم تكن هناك أي ذكريات بصرية تُسند الإدراك، ولم يكن هناك عالمٌ من الخبرة والمعنى ينتظره. لقد رأى، لكن ما رآه لم يكن له أي ترابط.“
يَقودني كلامه هذا لفكرة «المركزية للإدراك التنبؤي » حيث يُخمن الدماغ الرؤية قبل حتى أن يرى، من خلال توقعات سابقة و مشاهد بصرية مُتكررة و من بعدها يجمعها مع الأشارات الحِسية المُستقبلة كاللون و الضوء و الحركة. الرؤية و الإدراك يأتيان من الداخل قبل الخارج. نحن نرى العالم من داخل أجسادنا قبل أن نراه من خارجنا.
هُنا نتوصل إلى أن المركزية للإدراك التنبؤي لا تقتصر فقط على الرؤية البصرية بل تمتد إلى الرؤية الفكرية. الانسان لا يتعلم فقط كيف يرى، بل أيضًا كيف يفكر.
فحين يُواجه الأنسان موقفًا، ينظر إليه الدماغ أولًا بنظرة الأفكار التي أُنشئ عليها، المُجتمع الذي تُكون فيه، تجاربه، مخاوفه، أهوائه.. قبل أن يواجه الموقف بنظرة بعقلانية. الحيادية و الموضوعية أمران يُناقضان بيولوجيا الدماغ، لأننا من الأساس، لا نَرى بصريًا بحيادية، فكيف حين يمتد إلى أمر أكثر تعقيدًا.. أيديولوجيًا؟
يَقول د. أنيل ك. سيث في مقاله ”علم الأعصاب للواقع“
” وحتى لو بدأت هذه الفروقات صغيرة، فإنها قد تتجذر وتتقوى مع استمرارنا في جمع المعلومات بطرق مختلفة، واختيار البيانات الحسية التي تتوافق أكثر مع نماذجنا الفردية الناشئة عن العالم، ثم تحديث نماذجنا الإدراكية بناءً على هذه البيانات المنحازة. ما أقترحه هو أن المبادئ نفسها تنطبق أيضًا على مستوى أعمق، تحت معتقداتنا الاجتماعية وصولًا إلى نسيج واقعنا الإدراكي“
إذن العملية هي كالآتي:
معتقد مسبق —> إدراك متحيّز —> انتباه انتقائي —> معتقد معزّز —> واقع مُحدّث
يَختم مقاله ليقول أن التعاطف الاجتماعي يبدأ بالتواضع العصبي، بما أننا لا ننطلق جميعًا من بيولوجيا عصبية واحدة..
فِكرة أننا ”نعيش في نفس العالم“ هي من المنظور العصبي، فكرة خاطئة.. لأن كُل فرد يَبني عالمه ذاتيًا من ماضيه، ذكرياته، مخاوفه، ثقافته يرى من خلالها العالم و بما أن الواقع شيء يُبنى، فالصراعات العقائدية و الأجتماعية و الفِكرية هي ليست فقط صراعات رأي، بل صراعات عوالم.
حِين يتصارع فردٌ مع أخر، لا يتصارع بِفكرة، بل بحقيقة قد عاشها و تم بنائها بمرور حياته و تجاربه، أَطلق عليها ”الحقيقة“ و الواقع أن الشخص المقابل الذي يُناقشه أيضًا يرى ”حقيقة“ اخرى بمنظور عالمه.
يبدأ الأمر بشيء صغير كالأوهام البصرية . تلك الصور الشهيرة حيث يرى البعض فستانًا أزرق وأسود، بينما يرى آخرون نفس الفستان باللونين الأبيض والذهبي. كلا المجموعتين تحصلان على نفس المُدخلات، لكن أدمغتهم تفسّر سياق الإضاءة بشكل مختلف بناءً على الافتراضات المسبقة حول الإضاءة، التباين، أو الزاوية. هذا ما نُسميه بالمعالجة التنبؤية predictive processing أي أن الدماغ يملأ الغموض مستخدمًا ما يتوقع أن يكون حقيقيًا.
و تُصبح الاختلافات أعظم، حول العالم لا الضوء.
من الأهمية أن أقول: فهم بيولوجيا تكوين الانحيازات سواء ُِفكرية أؤ حتى بين رفيقين مُتخاصمين لا يَهدف إطلاقًا لتبرير الإنحيار بحد ذاته. بل لبيان مدى هشاشة و قابلية التلاعب في آلية الإدراك.
لا يجب علينا أن نقف فقط عند فهم هشاشة الإدراك - بل أن نحمل تلك المسؤولية المعرفية للتشكيك و إعادة النظر في حياتنا بمنظور أكثر حيادية و عقلانية.
التعاطف، إذًا، يصبح فعلًا ثوريًا، لأنه لا يقتصر على فهم الآخر فقط، بل يتطلب أيضًا التجرد و الخروج من الذات، الدماغ، و الجسد. ومحاولة رؤية العالم من خلال منظور الآخر.
كما يُقال: "أنت مسؤول شخصيًا عن أن تصبح أكثر أخلاقية من المجتمع الذي نشأت فيه."
أختم معكم اليوم بأن أُذكركم بالطاولة التي بدأتُ مقالتي بها. كما أن للطاولة واقعين، فيزيائي و أخر إدراكي - فذلك أيضًا ينطبق على العالم الذي نقف عليه الان. للعالم واقع واحد موضوعي يتواجد بدوننا و آلاف العوالم الأخرى التي تتواجد من خلال أدمغتنا و أجسادنا.
- لارا غاندي
الكتاب الذي استندتُ اليه بقصة فيرجيل أن ترى و لا ترى. مقالات العالم أولفر ساكس في هذا الكتاب.
كتبت هذه المقالة في العربية و ترجمتها للانجليزية في المنشور the neuroscience of always)
being partly wrong)
المُراجعات
https://blogs.baruch.cuny.edu/art3061sp2015/files/2015/02/sacks-to-see-and-not-seeLR.pdf


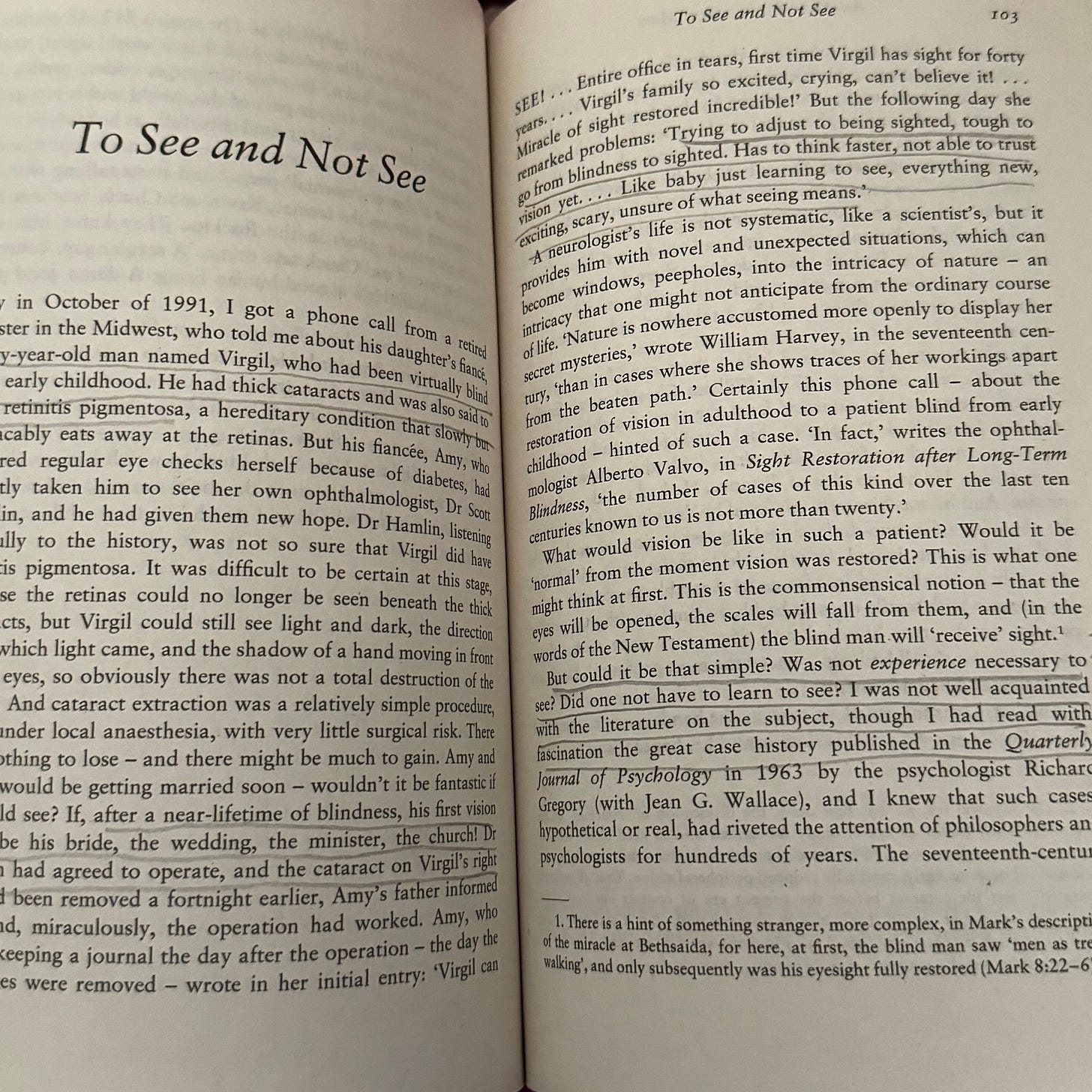
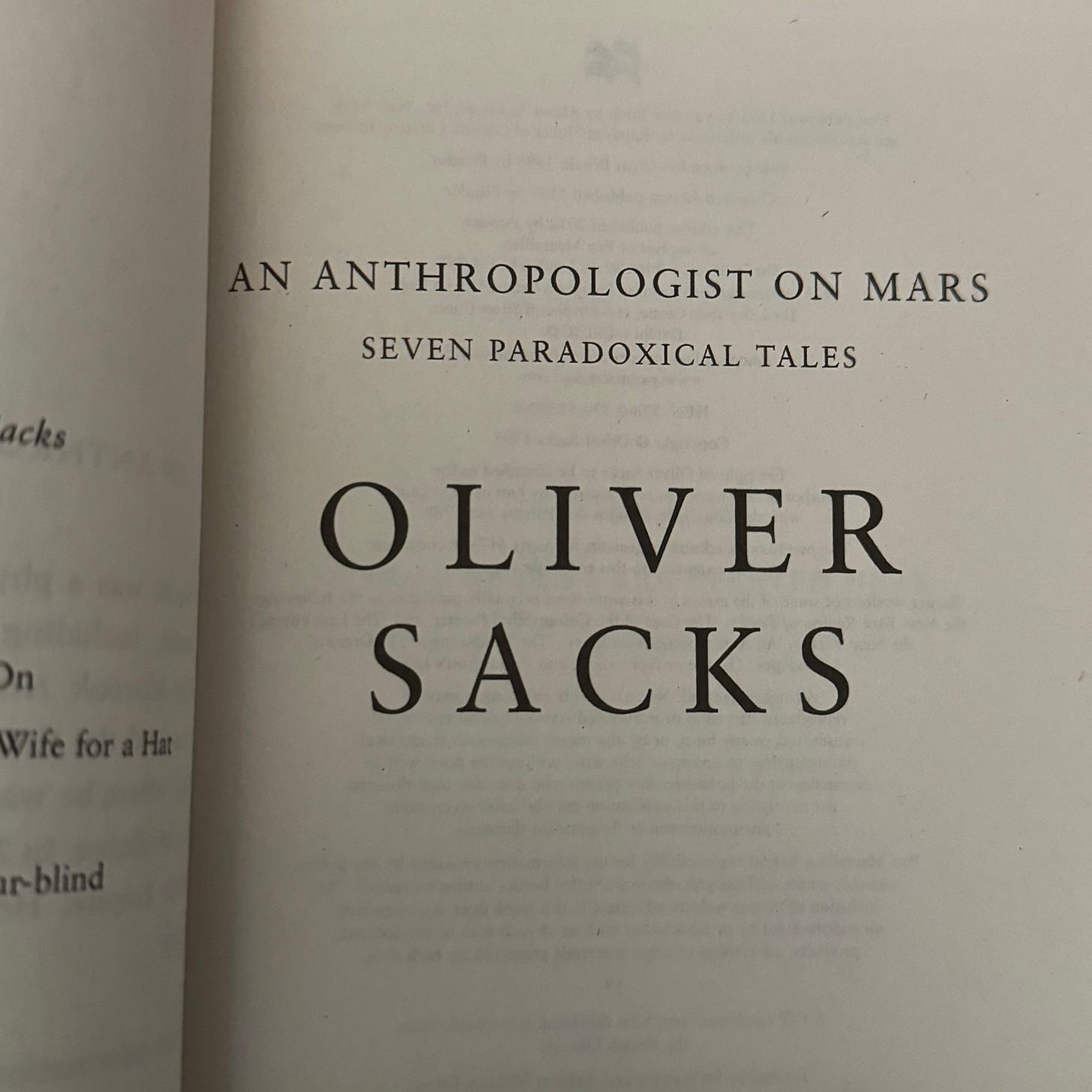
يا لارا،
كم كنتُ ممتنّة وأنا أتبع كلماتك كما لو أنني أتلمّس طريقًا داخل متاهة من الضوء والظل، متاهة لا يقودنا فيها سوى إدراكٍ هشٍ نرتديه كعدسة نُعاين بها العالم – لا كما هو، بل كما نشعره!
تبدأين مقالك بدعوةٍ غير اعتيادية: أن نشعر بأقدامنا على الأرض، كأنك تهمسين لنا بأن الرحلة هذه المرّة ليست إلى الخارج، بل إلى الداخل...ومن هناك، من بين جدران غرفتك التي رسمتها بالكلمات، تبدأين كشف الحجاب عن أعقد ما فينا "إدراكنا"
نعم، إدراكنا الذي نثق به كما لو كان يقينًا، بينما هو – فيزيائيًا – لا يتعدى تفسيرًا عصبيًا متحيزًا للذبذبات والموجات..ذكّرتني بميكانيكا الكم، حيث تتغير طبيعة الجسيم بمجرد أن نراقبه، وكأن في إدراكنا تدخلًا فاعلًا في الواقع، لا رصدًا بريئًا له.. ألسنا إذًا نحن – كما أشرتِ – من يصوغ العالم، كما يصوغ الفنان لوحته من ظلال الداخل لا من نور الخارج؟
وفي اختلاف العوالم بين الأفراد، فتحتِ بابًا عميقًا: أن صراعاتنا ليست فقط خلافات فكرية، بل تصادم بين حقائق مُشكّلة...كأن كل عقل يسكن كونًا صغيرًا، له قوانينه، جذوره، وسماؤه الخاصة!
لكن ما أثارني – وأرغب أن أناقشك فيه – هو:
هل يحق لكل إدراكٍ أن يُعامل كحقيقة؟ وإن كان لكل منا واقعه، فكيف نبني “جسرًا موضوعيًا” دون أن ندّعي امتلاك الحقيقة أو ننزلق إلى فوضى النسبية المطلقة؟
أراكِ تُشيرين إلى التواضع العصبي كقيمة جديدة، وهذا جميل – بل ضروري – لكن هل يكفي التواضع في عالم تتكاثر فيه “الحقائق” حتى تتقاطع وتتناقض؟ ماذا لو أن إدراكًا ما، كُوِّن على أسس عنف أو جهل أو إقصاء؟ هل نُجاريه احترامًا لاختلافه، أم نملك – ولو من زاوية الفيزياء الأخلاقية – أن نحتكم إلى “قيمة” تتجاوز الإدراك؟
أحببتُ كثيرًا تشبيهك للطاولة، فكما أن لونها وملمسها وتفاصيلها لا تنتمي لها بل لنا – فإن معتقداتنا قد لا تنتمي للحقيقة بل لأدمغتنا..
لكن لو امتلكتِ القدرة أن تخلعي عدسات الإدراك كلها – هل ترين أن شيئًا ما سيبقى؟ أم أننا نحن، فعلًا، ما ندركه فقط؟
لقد كتبتِ مقال لا يُقرأ فقط، بل يُعاد إدراكه!!
عبير~
طريقتك في طرح موضوع صعب مثل هذا جميلة جدا 🙏